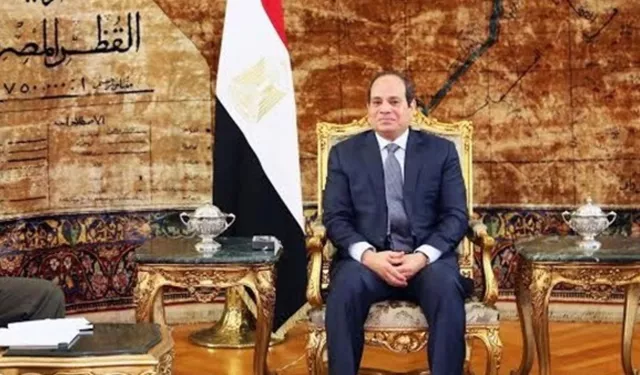
جمهوريةُ "المُلكِ لله"
لا يعبر عن الأزمة التي تتفاقم في مصر منذ ما حدث في الثلاثين من يونيو/حزيران 2013 أكثر من المشهد الراهن، البشر والحجر يؤيدون الرئيس في انتخابات منزوعة السياسة، يخوضها مرشحان أحدهما لا يخفي دعمه للآخر، وساسة غائبون ومعارضون ملاحقون وقانون يطبّق بانتقائية فجّة، مشهد يرسم ملامح عقد اجتماعي جديد يهدر كل قيم الجمهورية وسيادة الشعب ويؤسس حكمًا يستمد شرعيته من التكليف الإلهي.
أزمة تتفاقم في البلاد منذ أربع سنوات ونصف، ولكن لحظة الانتخابات وما صاحبها من ارتباك في إعداد المشهد، كانت اللحظة التي كشفت حجم المشكلة، الناجمة عن رغبة من يصنع القرار في الجمع بين أمورٍ تبدو بطبيعتها، متناقضة.
ثمة رغبتان لا يجتمعان حول المشهد اللازم في عقل من يصيغون ملامح الصورة، الأولى تتعلق بتغييب السياسة بشكل كامل عن العملية الانتخابية، والثانية تتعلق بضرورة إخراج مشهد يليق بعملية انتخابية بين مرشحين متعددين، للنأي بالنفس عن سهام النقد القادم من الخارج، حيث لجان العلاقات الخارجية في الكونجرس، والتي تمنح المعونات وتسلح الجيوش، تراقب عن كثب حالة حقوق الإنسان وخطوات الإصلاح السياسي.
في السابق، كان هناك إدراك أن إخراج مسرحية جيدة لعملية انتخابية دون بعض السياسة أمر صعب، فقدّم مبارك بعض التضحيات عام 2005 وعرّض نفسه لمنافسة شبه جديّة من أيمن نور، ولكنّه في النهاية أخرج صورة ليست سيئة، أما اليوم، فهناك من يعتقد أن بإمكانه الجمع بين المتناقضات.
لا شك في أن السيسي سيفوز في أي انتخابات تعددية أيًا كان منافسه، ولكن الانتخابات تعني استدعاء الحديث عن الحقوق السياسية والمسؤوليات الدستورية، وتعني مرشحين متنافسين ومناظرات وحملات انتخابية تجوب الشوارع وتعقد المؤتمرات، تعلق اللافتات، وتفتح عيون الناخبين على احتمالات أخرى، برامج تقدم حلولًا أخرى لمشاكل يُقال لنا دائمًا إن لا حلول لها سوى المزيد من الفقر، ومناخ يفتح هامشًا للمشاركة السياسية بدأت عملية إغلاقه مع انتصار الثورة المضادة في الثالث من يوليو/تموز 2013.
لا يبدو أن هناك استعدادًا لإعادة فتح هذا الباب مجددًا، فدرس 2005 الذي آل إلى 2011 وما بعدها ما زال عالقًا في الأذهان، عندما تبلورت حركة احتجاجية كبيرة في الشارع المصري بعد أول انتخابات تعددية كان فوز مبارك فيها محسومًا لا جدل فيه، تدحرجت -الحركة الاحتجاجية- ككرة ثلج، إلى أن أطاحت بمبارك نفسه بعد ست سنوات.
ولأن مشاهد الميدان في يناير مكروهة وما زالت تثير القلق، فلم يكُن هناك بد من صياغة عقد اجتماعي جديد، لا يرتب على من في السلطة أي تنازلات أو تضحيات كما فعل مبارك.
من أجل نزع السياسية من المشهد الانتخابي، جرى التعامل بحسم مع كل من سوّلت له نفسه إعلان عزمه الترشح، ومن أجل رسم الصورة التنافسية منزوعة السياسة، كان لازمًا توفير منافس من المؤيدين، وبسبب غياب الكفاءة حتى في إخراج مثل هذه المسرحيات، تأخر تأمين المنافس حتى اللحظات الأخيرة، فالكل كان مشغولًا بدعم الرئيس.
ومع الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، ومع تحقق الرغبة الأولى بعدم وجود أي مرشح منافس، بدأت خطوات تحقيق الرغبة الثانية، وهي العثور على منافس، ولكن لم يكن ممكنًا أن يمر ذلك أيضًا دون مدح السلطة، والهجوم على المعارضة.
عندما يتعرض كل من أعلن عزمه المشاركة في الانتخابات لهجوم إعلامي ضارٍ، أو مضايقات أمنية، أو ملاحقات قانونية، أو محاكمات وسجن، أو اعتداءات بالضرب في الشوارع، أو ترحيل قسري من دولة صديقة سبقه بساعات منعه من مغادرتها، لا يصح أن يبدي أحد دهشته من غياب كل مرشحي المعارضة.
المقدمات دائمًا تُرتب نتائجها المنطقية، فعندما تطلق النار على رأس أحدهم، لا يصح أن تندهش لمقتله!
استنكر الإعلام غياب المنافسين، وتساءل مستنكرًا عن مسؤولية الدولة عن بوار الحياة السياسية في مصر والتي لم تفرز أي مرشح طامح للرئاسة، ووجه اللوم للمعارضة التي لا شعبية ولا أرضية لها، وكأننا نعيش في ظل منظومة تتيح للأصوات المعارضة الحياة.
يمكن لساعات أن نشرح كيف أصبح التعبير عن أي معارضة لما يجري أمرًا يرتب آثارًا شديدة الخطورة، حالات لا حصر لها لشباب قضى سنوات في حبس احتياطي على ذمة قضايا لا يُبت فيها، أو سجن طويل في اتهامات واهية، مسيحيون أدينوا بالانضمام لجماعات إرهابية، إعلاميون مهنيون غادروا البلاد واحدًا تلو الآخر، باحثون أجانب قتلوا وألقي بهم على قارعة الطريق، أحزاب سياسية لم تعد قادرة على إقامة المؤتمرات، إعلام خاص بات أليفًا تمامًا، فضائيات أصبحت فجأة مملوكة لرجال أعمال مقربين من الدولة، وهو ما أعربت مراسلون بلا حدود عن قلقها بشأنه، في بيان صدر في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنك لن تتمكن، عزيزي القارئ، من الوصول إليه إذا كنت في مصر، لأن موقع المنظمة، والمواقع الصحفية التي نقلته عنها، جميعها محجوبة، ضمن أكثر من 400 موقع لمنظمات حقوقية دولية ومحلية، ومواقع صحفية مستقلة ما زالت تتمسك بمهنيتها.
ولكننا هنا لن نبرر غياب المرشحين بدعاوى تضييق وقمع صادرة من القوى المعارضة أو من تقارير منظمات حقوقية، فلم تعد المعارضة وحدها من تتحدث عن القمع، فمن يقف على الجانب الآخر، جانب الدولة، بات أيضًا يعترف بأن المناخ معادٍ للحريات الأساسية للمواطنين، وهو تحوّل لافت، لأن العادة جرت والضرورة اقتضت دائمًا، في الديكتاتوريات الكلاسيكية، أن تُنكر مثل هذه الأمور.
في السابق كانت الدولة واعية لضرورة أن تقدم نفسها كمظلة تحفظ الحقوق وترعى كل الأصوات. يسجن السادات معارضين ولكنه يشكر من قالوا لا ومن قالوا نعم، يسعى مبارك لتوريث الرئاسة لنجله ولكنه يتحدث عن الإصلاح السياسي وحرية التعبير ويؤكد أن أحدًا في عهده لم يسجن لرأي، أما اليوم فإن ذلك كله لم يعد مهمًا، لم يعُد قمع المعارضين تهمة تتنصل منها السلطة، بل واقع لا تنكره ولا ينكره من يعلنون تأييدها.
العقد الاجتماعي الجديد الذي يحكم علاقة السلطة بالمواطنين بنوده اختلفت، الالتزامات والحقوق والحدود المُعلنة للسلطة تغيّرت، خطابها، الذي كان منضبطًا، لم تعد لضبطه ضرورة على ضوء التطورات الجديدة، وبعيدًا عن كل ذلك، فإن التفاصيل الصغيرة تحكي كل شيء.
"الصورة الكاملة تقول إن هناك غيابًا للسياسة، وأنا هقول الكلام دا بقى والأجر على الله، طلعت بكرة ما طلعتش بكرة شالوني من ع الهوا يعني أنا هقول الكلام اللي لازم أقوله".
الاقتباس السابق مأخوذ عن الإعلامية لميس الحديدي، وهي إعلامية ذات صيت، لا تخفي دعمها للنظام السياسي الحالي، ولم تُعرف يومًا باتخاذ مواقف معارضة أو تتسم بالتحدي، ولكنها تعي وتعترف أنها قد تدفع ثمنًا باهظَا للكلام الذي ستقوله، والذي لم يتضمن نقدًا جديًا وحقيقيًا للأوضاع، لكنها فقط شكت من تغييب السياسة خلال السنوات الماضية، وشكت من أثر ذلك على المشهد الراهن، الذي يعيدنا إلى أيام الاستفتاءات الرئاسية.
في 25 أبريل/نيسان 2017 حضر السيسي المؤتمر القومي للشباب، وخلال مشاركته تلقى بعض الأسئلة من المشاركين في المؤتمر، كان أحدهم حول رد فعله إذا خسر الانتخابات المقبلة.
أول ما يلفت الانتباه في هذا السؤال أن من ألقاه فضّل إرساله دون كشف اسمه كما فعل زملاؤه الآخرين الذين أرسلوا أسئلتهم إلى الرئيس، وأن المحاور الذي ألقى السؤال على مسامع السيسي بدا متلعثمًا متحرجًا واعتبر أن صاحب السؤال "عاوز يورطني".
دائمًا في مصر، باستثناء أيام الثورة وحتى ارتدادها في الثلاثين من يونيو، هناك أسئلة عادية ومشروعة تورط من يطرحها، ولكن الجهر بذلك من السلطة أو ممن يحيطون بها، يغيّر قواعد اللعبة، ينسف بنود العقد الاجتماعي.
أما البنود الجديدة والقواعد التي باتت سارية، فلا يمكن أن يوضحها أكثر من إجابة الرئيس على السؤال الذي طُرح عليه.
لم يذكر التاريخ أن رئيسًا للجمهورية، في نظام جمهوري دستوره يحدد سلطات الرئيس، وصلاحياته، ومدة رئاسته وعدد مُدده، سئل عن موقفه في حال عدم فوزه في الانتخابات المقبلة، فأهمل مصطلحات الشرعية الدستورية وقبول نتائج الاقتراع وتهنئة المنافس، واختار الحديث عن أن المُلك لله يمنحه لمن يشاء وينزعه ممّن يشاء.
ولكن السيسي دائمًا ما يتحدث عن مسؤوليته "أمام الله سبحانه وتعالى قبل ما أكون مسؤول أمامكم"، رغم أن الدستور لا ينظم هذه المسألة، أي مساءلة الرئيس يوم القيامة.
لم يضع رئيس مصري فيما سبق نفسه مسؤولًا أمام أي أحد سوى الشعب، ولم يجاهر رئيس مصري أبدًا باعتبار منصبه "مُلكًا" حصل عليه كمنحة إلهية، بل دائمًا كان الحديث الرئاسي منضبطًا في مثل هذه الأمور، يراعي بنود العقد الاجتماعي، يعلن أنه يستمد سلطاته من الشعب، ويُسأل أمام الشعب.
ما حدث في الثلاثين من يونيو مهّد لنهاية الجمهورية في مصر، لا الجمهورية الثانية التي أسستها ثورة يناير ووئدت بعد ولادتها بسنة واحدة، بل حتى تلك الجمهورية العرجاء التي وضع الضباط الأحرار أسسها في 1954، والتي لم تكن أبدًا في أحلك لحظاتها وأقصى هزائمها، بهذا البُعد عن أسس وثوابت النظام الجمهوري، ولو كنا نتحدث هنا عن الأسس والثوابت الشكلية.
ولكن يبدو أن ثمة عقد اجتماعي جديد يُصاغ، المُلك فيه لله، يمنحه لمن يشاء، وينزعه وقتما شاء ممّن شاء، ولأن وحده من يمنح يحق له أن يحاسب، فمساءلة المسؤولين تصبح ضربًا من الخيال.
وهذا، يمكن أن نطلق عليه أي اسم نشاء، عدا أنه "جمهورية".
تذكير
في صيف 2010 لم يدُر بخلد مبارك أنه بعد عامٍ سيكون في السجن، هذه أمور لا يتوقعها أحد، ولكن ما حدث أنه في صيف 2011 كان متهمًا محبوسًا، وقد استفاد من قواعد اللعبة التي أرساها وهو في السلطة، فالحفاظ شكليًا على قيم الجمهورية وإطارها السياسي والقانوني، ضمن له محاكمة توفرت فيها حقوقه كمتهم.
على العكس من ذلك، في الجوار، ألقى القذافي بكل قيمة قانونية في مهب الريح، أسس نظامًا سياسيًا وضع قواعده بنفسه ولنفسه، اختار سلطاته، اختزل المؤسسات في شخصه، نكّل بالمعارضين بلا ضوابط، كانت هذه قواعد اللعبة التي وضعها لخصومه، فبدلًا من أن ينعم في صيف 2011 بسجن مريح ومحاكمة لا تُنتهك فيها حقوقه، كمبارك، اختطفته إحدى الميليشيات المسلحة وجرّته وسحلته وقتلته، ودفن في موقع مجهول فلم يعُد له ذكر.
من يمارس القمع بضوابط النظام الجمهوري، كمبارك، يعاقب بضوابط النظام الجمهوري، ومن يخرج لدى ممارسته القمع عن ضوابط النظام الجمهوري، كالقذافي، سينتهي كما انتهى القذافي. هذه هي قواعد اللعبة.
يحذروننا كثيرًا من الانزلاق إلى المصير الليبي، ونحن نعي الدرس جيدًا، ولكن لماذا لا يعون هم بدورهم، الدرس الذين يريدون منّا أن نتعلمه؟
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.